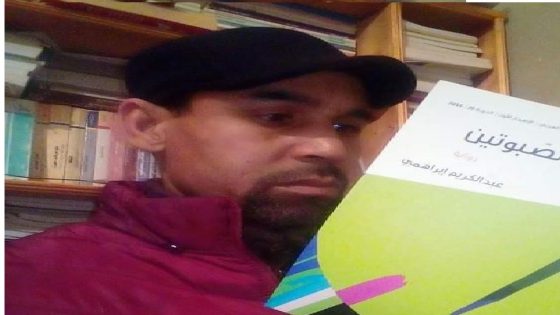بقلم : عبد الرحمان أهري
لما انتهيت، للمرة الثالثة ، من قراءة رواية ( رهين الصبوتين ) للكاتب عبد الكريم ابراهمي، اكتشفت أني أمام سارد مبدع و ممتع ، و أسلوب روائي متين و حبكة قوية يدلان على أن الكاتب مكث على إنجاز عمله مدة غير يسيرة بروية وتأن و بنفَس طويل.
و لما تأهبت للكتابة عن هذه الرواية بما يليق بها حضرت في ذهني مجموعة من الجوانب الفنية و الدلالية التي اعتاد النقاد تناولها في دراساتهم للنصوص السردية ( الثيمات، العنوان ، الشخصيات، الزمكان ، التشويق، و هلم جرا ) ، و وقع اختياري على موضوع ( التداخل بين البداية و النهاية في الرواية ) ، فهذا الإختيار لم يأت مصادفة بل لأن للكاتب لمسات و بصمات في هذا الموضوع، و رغم ذلك أعتبر هذا الإختيار مغامرة في موضوع شائك مسالكه ملتوية..و للأمانة العلمية أقر بأني استفدت كثيرا من الجانب النظري مما كتبه الباحثون و النقاد المغاربة كإدريس الناقوري و حميد لحميداني، و عبد الفتاح الحجمري، و جميل حمداوي، و بشكل خاص الناقد عبد المالك أشهبون من خلال كتابه ( البداية و النهاية في الرواية العربية ) (**) .
يقول أشهبون : ” لعل ما يسجل في الحقل النقدي العربي الحديث هو كثرة اهتمام نقادنا بالنص الروائي في مستوياته المعروفة : الشخصيات ، السرد ، الزمان ، و المكان ..لكننا قلما نجد انشغالا ملحوضا ، سواء على مستوى التنظير أو التطبيق ، بمكونين نصيين إستراتيجيين في بناء الرواية ، و يتعلق الأمر ب « البداية » و « النهاية » ، فقد صار هذا المكونان الروائيان من شدة الجهل بهما كالمعلومين اللذين لا حاجة إلى بذل جهد يذكر فيهما، و عليه فإن ما يطبع تناول الناقد و المبدع لهما كان لا يخرج عن دائرة التعميم تارة ، أو اللامبالاة و التجاهل تارة أخرى.
و من منظورنا الخاص ، فإن هذين المكونين « البداية » و « النهاية » قمينان بالدراسة و التحليل ، و ذلك لتظهير أهميتهما في كل تجربة روائية ، بالنظر إلى استعمالاتهما المتعددة ، و وظائفهما المتنوعة ، و رهاناتهما الفنية التي تختلف من روائي لآخر ، و من حساسية روائية لأخرى، فلا أحد ينكر أن سؤال كل من « البداية » و « النهاية » ينتصب شامخا أمام كل روائي يفكر في وضع اللمسات الأولى أو الأخيرة في رحلة الألف ميل الروائية ، رحلة روائية لا بد لها من نقطة بداية ، و مآل و نهاية .” (1).
و قد رصد الدكتور أشهبون مظاهر قصور النقد العربي في هذا المجال و من بينها أذكر :
-« حال الناقد هذا لا يبتعد كثيرا عن حال الروائي العربي الذي لا يدخل في الحسبان أهمية البداية و النهاية في طقوس ما قبل الكتابة لديه » (2) .
و قبل الدخول في تفصيل القول في الموضوع أقدم خلاصة مجملة حول الرواية ، لأنها تفيدنا في هذه المقاربة . و من هذا المنطلق فالرواية تحكي عن شخصية محورية و هي شخصية غيلان ، التي نجد إلى جانبها شخصيات أخرى غيرت في مسار حياته.
فغيلان قضى شطرا من حياته الطفولية بالبادية مع والديه عمران و سالمة ، ومع جديه الحاج عبد الحق و أم الخير ، و مع عمه بشير و زوجته سميرة ..
و بعد أن أتم عمر غيلان الطفل سبعة أعوام جيء به إلى بلدة صغيرة ( هكذا سماها السارد و سماها كذلك بالمدينة القديمة و هي مدينة صغيرة ) مع والدته سالمة من أجل ولوجه المدرسة ، بعد إقناع جده ، الذي امتنع في البداية، من طرف الفقيه السيد المختار ، و بإيعاز من عمران ، فسكن الطفل غيلان مع والدته دارا مهجورة تسمى بدار أبي السمادير كنية إلى صاحبها الحاج عبد الحق أبي السمادير . و ظل والده عمران يزورهما عندما يتنقل بين البادية و البلدة..
ففي البلدة الصغيرة كسب غيلان الطفل الأصدقاء و هم : ميمون و إبراهيم و السارد الذي تبين فيما بعد أن إسمه عدنان ابن الفاكه، فكان يجلس معهم حول رقعة ضوء عمود كهربائي خشبي في مكان قريب من داره ، فيسهرون وقتا يسيرا من الليل يحكون الحكايات و القصص ، و يتبادلون النكت و الطرائف ..
و إلى جانب الحكايات كانوا يخرجون لاكتشاف عوالم أخرى من أجل المتعة و البحث عن مغامرات يجدونها بين ضفتي الوادي و أشجار النخيل ..
و تقدمت السنون بغيلان ، فلما أصبح شابا في مقتبل العمر عين موظفا بالبريد في مدينة سماها السارد بالمدينة العملاقة ، لأنها الوحيدة التي يوجد فيها المركز الوطني لتكوين موظفي البريد ..و شبه غيلان حاله في المدينة بحال سجين يعيش في عتمة موحشة . و بالرغم أنه يجوب كثيرا خلال هذه المدينة بسيارته فإنه لم يألفها و لا يحفظ منها غير البيت و مقر العمل . و شبه أيضا المدينة بصندوق عملاق من حديد .لأنها تأكل القيم و المشاعر مثلما تأكل النار الهشيم .
فعندما تنتاب غيلان حالات نفسية مؤلمة في المدينة العملاقة يتقرفص خلف ذاكرته لينعم براحة نفسية تمنحها له ذكرياته الجميلة في البادية لأن فيها مراتع الصبا و ملاعب الطفولة ، و يجد راحته النفسية أيضا في ذكرياته ببلدته الصغيرة التي قضى فيها شطرا من حياته الجميلة مع والدين يخفق قلباهما بالحب ، و مع جده الحاج عبد الحق الذي نهل من معينه الحكمة ، فبالرغم أن هذا الجد يكره المدينة و يسبها فإن القدر شاء أن يكون قبره فيها.
و من ذكريات غيلان أيضا ببلدته الصغيرة بداية شرارة حب أصابت قلبه و أحدثت فيه رجة ، و هو ابن العشرين سنة، و تعلق قلبه بفتاة ( ما بين السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمرها ) و هي بنت صديق والده عمران يدعى ميلود .
و حدث أن رافق غيلان والده عمران إلى دار ميلود فجاءت الفتاة إلى منظرة الضيوف بصينية الشاي أولا ، و بعد ذلك بطبق خزفي به خبز فطير ساخن رُفس ببيض و سمن و عسل. فرأى منها ما رأى ، فرأى في عينيها رحمة و حنانا ، و جمالا يأخذ سحره الألباب .
رغم قسوة المدينة العملاقة على قلب غيلان فإنه لم يترك هذه الذكرى عابرة ، بل أعادها إلى الواقع ، و أشرق الأمل في عينيه ، بعد أحلامه المتكررة، للبحث عن هذه الفتاة صاحبة الهدوء كما يسميها بينه و بين نفسه قبل أن يعرف اسمها الحقيقي ( أميمة الدحراوي ) . و مع انعطاف مجريات الأحداث إلتقى غيلان بصاحبة الهدوء ، بحي الأمل في ضاحية أخرى من البلدة الصغيرة .. فكانت لهما في الحب بداية ثانية فاستأنفا حياتهما و رُزقا بطفلة سماها سالمة تيمنا بإسم والدته التي رحلت إلى الأبد
يتبع